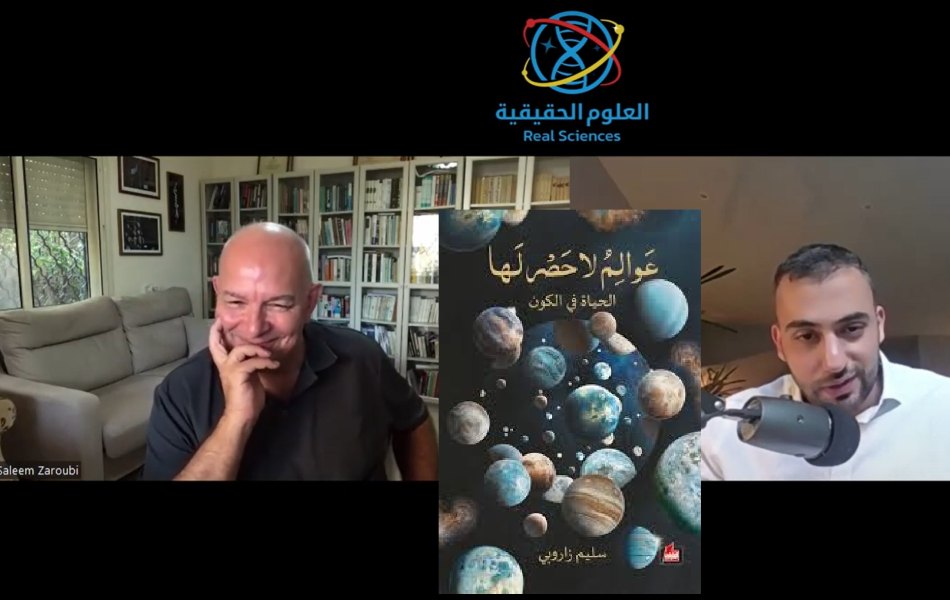Podcast: Play in new window | Download
ذكرتم ان المريخ كان يصلح للحياة قبل مليار سنة او نحو مليار سنة، لكن هل كانت هناك حياة ام لا حسب الادلة التي جمعت من خلال جميع الرحلات التي ذهبت الى المريخ؟
(للقراءة او المشاهدة او الاستماع للجزء الأول يمكن مراجعة الرابط)
حتى الان لم يكن هناك بحوث كافية او ادلة كافية للإجابة عن هذا السؤال. قضية وجود الحياة هي قضية معقدة ايضا. عندما نتحدث عن الحياة على المريخ، فهل هي حياة بدائية جدا على مستوى الخلايا، ام هل وجدت مستحاثات بسيطة تدل عليها؟ هذا ما اقوله: لا توجد مستحاثات. تذكر انه على الارض، حتى تجد مستحاثات معينة، يجب ان تفحص الارض وتعرف اين تذهب، فهي ليست موجودة في كل مكان. بعدما وصلنا الى هذه المرحلة، لكن في الاسبوع الماضي، قبل ايام، كان هناك خبر انهم وجدوا اثار حياة على المريخ او ادلة اولية لآثار حياة. فهل هي اثار حياة ام ظاهرة طبيعية لا علاقة لها بالحياة؟ هذا يحتاج وقتا لدراسته.
هذا هو سبب تركيز وكالات الفضاء العالمية، الامريكية والاوروبية والصينية والهندية واليابانية. اقصده، لاحظ انني لا اذكر الشرق الأوسط، فنحن خارج هذه اللعبة. تركيزها على المريخ، فيجب دراسة المريخ اكثر وبشكل ادق حتى اذا وجدت عليه حياة، نقدم شيئا اخر للناس الذين يأتون اليه على الاقل.
عندما كان كلينتون رئيسا لأمريكا، تم اكتشاف صخرة او الاعلان عن اكتشاف اثار ما يشبه الدودة، الدودة الصغيرة في قلب صخرة مصدرها المريخ. المريخ بين فترة واخرى تصل صخور منه – نادرا لكنها تصلنا. كيف تصلنا؟ اذا سقط على المريخ نيزك، فتنطلق منه صخور الى الفضاء وجزء صغير منها جدا يصلنا، أي يصل الارض. فهناك عدة صخور لا نعرف مصدرها من المريخ، ففي واحدة من هذه الصخور وجدوا حياة مجهرية تشبه الدود. وفي ذلك الوقت كان الاقتراح ان هذه ظاهرة حياة. بعد الدراسات هناك خلاف على هذا الموضوع، على الاغلب ان هذه ليست كائنات حية وانما ظاهرة طبيعية لا علاقة لها بالحياة.
فحتى نتأكد من ان ما تفحصه او ما ترصده هو مصدر حياة سابقة، فالقصة طويلة، وليست سهلة، خاصة لأننا لا نتحدث عن كائنات كبيرة تحتوي على هيكل عظمي وما الى ذلك. نحن نتحدث عن بكتيريا، وكائنات وحيدة الخلية وما الى ذلك التي لا تحتوي على بناء مورفولوجي معين من حيث الشكل والمظهر، فلا يمكنك ان تقول ان هذه حياة وانتهى الامر. فالأمر اعقد مما نتصوره. لكن هناك بحوث وجهود حثيثة للبحث في وجود هذه الامور، لأنه مهم اذا عرفنا اصل الحياة على الارض من نشأة وما الى ذلك.
دكتور، كنت ارغب في سؤال ربما غطيتموه تقريبا، وهو الحياة كظاهرة طبيعية. لكن ما معنى ذلك؟ وايضا اود الانتقال لأمر اخر قرأته ويجذب اهتمامي، وهو النظرة الفيزيائية المحضة للحياة. مثلا قضايا مثل التخلص من الانتروبيا عبر التكاثر، والاساس الفيزيائي للحياة. ولا ادري ان كان هذا يتصل مع مفهوم الحياة كظاهرة طبيعية او مع امر اخر ايضا ذكرتموه ربما في سياق مقارب، وهو مشكلة ضبط الثوابت الدقيقة (the fine-tuning problem). فهذه كلها قضايا اراها مثيرة للاهتمام، واكيد انتم اعلم بكيف يمكن تغطيتها وان كانت متصلة ام لا.
دعني أبدأ من النقطة الأولى لأتوسع في فكرة قلتُها: “الحياة ظاهرة طبيعية”. أولاً، عندما نذهب إلى الطبيب سواء كنا مرضى أم لا، فإن الطبيب يتعامل مع الجسد في النهاية على أنه مادة كيميائية، أقصد تفاعلاتٍ كيميائية. فحياتنا مبنية على هذا الأساس. عندما نصاب بالصداع نتناول الأسبرين لأنه يحدث تفاعلٌ كيميائي يوقف الصداع. وإذا كان ضغطنا مرتفعاً نتناول مادة كيميائية تخفض ضغط الدم، وهكذا. هذا هو المبدأ الأساسي في الطب، فهو يتعامل مع الجسد كآلة، كشيء طبيعي، لا يتعامل معه على أنه روح فحسب، بل يتعامل معه كجهاز يعمل، وأحياناً يتعطل، وأحياناً يزداد الحمل عليه، وأحياناً تختل مواده. هذا بالطبع على المستوى الأولي.
بالإضافة إلى ذلك، إذا نظرنا إلى تاريخ الحياة، نجد أن الحياة كما ذكرت ظهرت مبكراً جداً. فعمر الأرض يقدر بـ 4.5 مليار سنة، وفي اللحظات الأولى من أول 500 مليون سنة كانت الأرض ساخنة، وشهدت أحداثاً دراماتيكية مذهلة. على سبيل المثال، في بدايتها وخلال أول 10 إلى 20 مليون سنة، اصطدم بها جسمٌ كبير – أقصد أن هذا الاصطدام أدى عملياً إلى تشطير الأرض، فانفصل عنها جزء كبير تحول إلى القمر. فالقمر في تاريخه جزء من الأرض، ونعلم هذا من تركيبه الكيميائي وكذلك من حجمه. فالقمر كبير بشكل ملحوظ، أقصد كبير نسبياً مقارنة بحجم الأرض. فهناك أقمار أخرى تكون أصغر حجماً مقارنة بكواكبها، لكن المشتري كبير جداً – أكبر من الأرض بألف مرة – بينما يعتبر القمر بالنسبة للأرض جسماً كبيراً بشكل غير عادي. والسبب في وجوده هو تلك العملية الاصطدامية التي يبدو أنها حدثت في بداية تكوين الأرض. لذا لم يكن من الممكن وجود حياة في تلك الفترة المبكرة.
من الخصائص الأخرى للأرض المبكرة أنها لم تكن تحتوي على ماء. فالماء لم ينشأ مع الأرض، ونحن نعرف لماذا؟ لأنه أثناء عملية النشوء كانت الحرارة مرتفعة جداً ونحن قريبون من الشمس، فكان الماء يتبخر قبل تكون الأرض. فالماء الموجود – أقصد في المنطقة القريبة من الشمس – كان سيكون في حالة تبخر، بينما في المناطق البعيدة يكون متجمداً. هذه المنطقة تسمى “خط الجليد”، وبالنسبة للشمس فإن هذا الخط يقع بعيداً عنها، أما نحن فكنا في الداخل حيث لا وجود للماء بشكل طبيعي. لذلك عندما تشكلت الأرض لم يكن عليها ماء. كان على الماء أن يأتي من مكان آخر، ونحن نعلم تقريباً – بل نحن شبه متأكدين – من مصدر هذا الماء: لقد جاء من النيازك.
في مرحلة محددة من تاريخ الأرض، حدثت تصادمات هائلة مع نيازك جلبت المياه إليها. استمرت هذه المرحلة بضع مئات من ملايين السنين، وتُعرف بالإنجليزية باسم “Late Heavy Bombardment”، أي القصف المتأخر، حيث تعرضت الأرض لاصطدامات نيزكية مكثفة.
كانت هناك فرضية أخرى تشير إلى أن المياه قد تكون جاءت عبر المذنبات، لكن المعرفة الحالية تؤكد أن مصدرها الأساسي هو النيازك، وذلك due to اختلاف التركيب الكيميائي للماء – لأسباب علمية لا يتسع المجال لشرحها هنا.
عندما بردت الأرض – بعد حوالي أربعمائة إلى خمسمائة مليون سنة من توقف تلك الظروف العنيفة والاصطدامات واستقرار الوضع – نشأت الحياة. فأول دليل على وجود الحياة يعود إلى 3.7 مليار سنة، بينما يعتقد الكثيرون أن أشكال الحياة الأولى ظهرت قبل أربعة مليارات سنة.
في اللحظة التي أتيحت فيها للأرض فرصة لنشوء الحياة، ظهرت الحياة عليها. وهذا أمر مدهش حقاً. ما يعنيه هذا أن تكوّن الحياة ليس أمراً صعباً، بل هو ليس معقداً بشكل جنوني.
سأعطيك سبباً آخر لقولي هذا: عندما ننظر إلى مركبات الحياة الأساسية، نجد بالطبع عناصر مثل الكربون والهيدروجين والنيتروجين وغيرها كما ذكرنا، لكن هناك أيضاً مركبات كيميائية خاصة بالحياة. هناك أربعة أنواع من هذه المركبات المعقدة، جزيئات معقدة هي: البروتينات، والدهون (التي تسمى Lipids)، والنيوكليوتيدات التي تكوّن الأحماض النووية مثل DNA، والسكريات.
عندما ن الفضاء، نجد آثار هذه المركبات. ففي الكون الواسع، عند انفجار النجوم وغيرها، نرى جزيئات عضوية معقدة موجودة في الفضاء. منها الأدينين – وهو أحد المركبات الأساسية في DNA – الموجود في الفضاء ويمكن رصده. كما توجد نيازك من النوع المعروف باسم “الكربونية” التي تتكون principalmente من الكربون، ويمكننا دراستها وتحليل تركيبها الكيميائي.
ففي المغرب، على سبيل المثال، عُثر على نيزك شهير من هذا النوع (وفي تونس أيضاً)، وأظهر التحليل الكيميائي للصخرة النيزكية احتواءها على مواد عضوية تتضمن الأدينين والأحماض الأمينية التي هي مركبات البروتينات وغيرها. فالكون يصنع لبنات الحياة في كل مكان، ونجد هذه اللبنات منتشرة في كل مكان.
وهذا ما اكتشفه شخص آخر – أحب أن أذكره في سياق مختلف – وهو تجربة “ميلر”، التي يمكننا العودة إليها لاحقاً ومناقشتها بتفصيل. عندما نعيد في المختبر محاكاة الظروف التي كانت سائدة على الأرض في بداياتها، بما في ذلك تركيب الغلاف الجوي المبكر، ونضيف شرارات كهربائية البرق وخلط المواد – كما نتوقع أن يكون الحال في الغلاف الجوي الأول للأرض – تنتج أيضاً مواد عضوية، منها الأدينين ومركبات أخرى مشابهة، بالإضافة إلى المواد البروتينية وغيرها. إنها نتيجة مذهلة حقاً.
يبدو واضحاً أن مركبات الحياة منتشرة في جميع أنحاء الكون. هذا لا يعني أن هذه المركبات تتحول تلقائياً إلى حياة، لكن الأرض تمثل مثالاً حياً: فما أن استقرت وبردت حتى بدأت الحياة بالظهور عليها. والحياة التي نشأت على الأرض كانت بالطبع بدائية، تتألف من كائنات وحيدة الخلية. أما الكائنات المعقدة، ما نسميه متعددة الخلايا، فقد نشأت فقط قبل 500 إلى 600 مليون سنة، أي أنها لم تكن موجودة منذ البداية.
معظم أشكال الحياة عبر التاريخ الجيولوجي كانت وحيدة الخلية، وليست معقدة. بل إن معظمها لم يكن حتى من نوع الخلايا المشابهة لخلايانا، بل كانت من نوع آخر يسمى “بدائيات النوى”، بينما تسمى خلايانا “حقيقيات النوى”. فالبكتيريا مثلاً خلاياها تفتقر إلى نواة محددة. والحياة على الأرض خلال معظم تاريخها كانت من هذا النوع البسيط.
هنا تكمن إجابة سؤالك: لماذا أعتقد أن الحياة ظاهرة طبيعية؟ لأننا نراها تتسم بتنوع هائل، وتتكيف مع بيئاتها وشروطها المختلفة، ولها تاريخ محدد نعرفه بدقة. والأمر المذهل أيضاً أن جميع أشكال الحياة تعتمد على الهيكل الأساسي نفسه: الخلية والـ DNA والعناصر نفسها. فأنا والبكتيريا لدينا DNA. إنها حقيقة مدهشة: فأنا لست مختلفاً كلياً عن البكتيريا. فالكائنات المعقدة – من حيث سلوكنا وإدراكنا ولغتنا ووعينا وذكائنا – تشترك في الأساس الكيميائي والهيكل الخلوي المتشابه. حتى الآثار البكتيرية في خلايانا، مثل الميتوكوندريا التي تحمل DNA خاصاً بها، تظل شاهداً على تاريخ تطور الخلايا المعقدة في الحياة.
فلذلك أتعامل مع الحياة كظاهرة طبيعية. الحياة، الوعي، المدركة التي تفكر، التي تتعامل، التي تتساءل عن موجودة في الكون، ظهرت مؤخراً، ليست ظاهرة من بداية الكون. فهذا الجواب لهذا السؤال.
لقد استبقتُ الأمور بالسؤال الثاني حول الإنتروبيا. لكن لعل الفارق الجوهري بيني وبين البكتيريا يكمن في مسألة التعقيد. لقد تطرقتم في الكتاب بشكل موسع إلى مفهومي التعقيد والإنتروبيا، وقد جئتُ بالمثال الذي أمامنا: كيف نفسر عملية حيوية مثل التكاثر على أنها آلية للتخلص من الإنتروبيا؟ بكلمات أخرى، كيف يمكننا فهم الظواهر الحية من منظور فيزيائي بهذه الطريقة؟
وما الذي يحدث على مستوى التعقيد؟ ولماذا بقيت البكتيريا على حالها بينما استمر هذا التعقيد بالتطور في اتجاه آخر؟ فتطورت إلى كائنات متعددة الخلايا، ثم ظهر التكاثر الجنسي، وصولاً إلى ظهور الذكاء لاحقاً. وكل هذه العمليات تبدو بشكل أو بآخر مرتبطة بمفهوم التعقيد، هذا صحيح.
دعوني أوضح أولاً نقطة قد لا تكون واضحة للجميع. سأعرّف الإنتروبيا، وعندما أتناول هذا الفرع سأشرح للمستمع ما نقصده عندما نتحدث عن الإنتروبيا. ولكن قبل ذلك، يجب أن أشير إلى أن حتى الخلية البكتيرية – وقد تطرقتُ للفرق بيننا وبينها من حيث التعقيد – هي في الواقع معقدة بشكل هائل. فالبكتيريا، على سبيل المثال، تتكاثر عبر انقسام الخلية إلى قسمين. أي أن الخلية البكتيرية الواحدة تنقسم لتصبح خليتين مستقلتين. هذه آلية تكاثر تختلف عن تلك الموجودة في الكائنات الأكثر تعقيداً.
السؤال المهم هو: كيف تتمكن البكتيريا عند تكاثرها من الحفاظ على المعلومات الموجودة داخلها؟ هذا المستوى من التعقيد والتنظيم ليس أمراً يسيراً. وهنا نصل إلى نقطة مشتركة بين جميع أشكال الحياة – فالتعقيد سمة عامة لكل مظاهر الحياة. حتى البكتيريا تمثل نظاماً معقداً للغاية. وهنا تبرز الملاحظة الأولى – صحيح أننا أكثر تعقيداً منها – لكن إشكالية التعقيد تطرح نفسها حتى مع البكتيريا. فما علاقة هذا بقوانين الفيزياء؟
أريد أن أناقش مسألتين. المسألة الأولى التي أعتبرها بالغة الأهمية، ثم أنتقل إلى قضية الإنتروبيا والقانون الثاني للديناميكا الحرارية الذي يلعب دوراً محورياً في هذا السياق. إحدى النقاط التي خصصت لها حيزاً كبيراً في الكتاب هي ما يُعرف بمبدأ “الانبثاق” (Emergence). وما أعنيه به – ويمكن ترجمة Emergence بالنشوء التكاملي أو الانبثاق، وهي الكلمة التي استخدمتها في الكتاب – هو ظهور خصائص جديدة من تفاعل مكونات بسيطة.
سأقدم لكم مثالاً عليه: أعتقد أن هذه إحدى أهم خصائص قوانين الفيزياء – أو قل قوانين الطبيعة – التي أسعى لتسليط الضوء عليها في الكتاب.
ما المقصود هنا؟ قوانين الطبيعة في الفيزياء أفهمها بشكل أساسي وبسيط، لكن في ظروف معينة، تنبثق من هذه القوانين الأساسية البسيطة – عند النظر إلى الواقع على مستويات مختلفة – ظواهر جديدة تنشأ وتظهر وكأنها خرجت من العدم.
هذه الظواهر أضرب لها مثالاً: الحرارة. نحن نفهم الحرارة – أضع يدي على جسم ساخن فأشعر بها وأدرك معناها. الحرارة شيء نختبره ونتعامل معه، لكنها في الفيزياء ليست مفهوماً أساسياً. فنحن نفسر الحرارة – مثل حرارة الغرفة – على أنها حركة عشوائية لذرات الغاز المحيط بنا، وهذا ما يعطينا الإحساس بالحرارة. فذرة واحدة لا تمتلك حرارة، بل تمتلك حركة. إذن الحرارة مفهوم منبثق، مفهوم متولد – هذه الكلمة التي كنت أبحث عنها – في الكتاب – إنها مفاهيم متولدة، تنشأ من ظواهر أعمق منها.
وهذا يحدث في كل مرحلة أو كل مستوى من مستويات الواقع. أعطيك مثالاً أبسط من الحرارة: اللزوجة. مادة لزجة، ما معنى أن تكون المادة لزجة؟ يعني عندما أمسكها تكون هناك مقاومة، نوع من المطاطية أو المخاطية. هل ذرة واحدة أو جزء من هذه المادة تكون لزجة؟ لا معنى لهذا. هذه الخاصية تنبثق لأنها – كما يسمونها – ظاهرة جماعية، حيث ينشأ من تجمع عدد هائل من الجزيئات معاً ظاهرة جديدة، مثل الحرارة واللزوجة وغيرها.
هذا يحدث في الفيزياء. فمثلاً قوانين نيوتن – ونحن نعلم أنها ليست القوانين الأساسية في الفيزياء – لكن على مستوى معين من الواقع، بأبعاد وسرعات محددة، تظهر قوانين بسيطة مثل قوانين نيوتن. هذه القوانين تنبثق، أي تنشأ من قوانين أعمق منها، وتظهر كأنها قوانين جديدة مختلفة، لكنها في الواقع انعكاس لتلك القوانين الأعمق أو نتاج لها.
ما النقطة الجوهرية في سياق حديثنا؟ برأيي، هذه أهم خاصية في قوانين الطبيعة. هناك أمر عجيب في هذه القوانين: ففي كل مرحلة، كلما نظرنا إلى الواقع بمنظور أقل تفصيلاً، تظهر لنا ظواهر جديدة. فالحرارة تظهر على مستوى الغرفة – بينما على مستوى الذرة لا وجود لمفهوم الحرارة – كما تظهر في العلوم الكيميائية. إنها ظاهرة متولدة عن الفيزياء، عن فيزياء الذرات والجزيئات. فبشكل مفاجئ، تكتسب هذه المواد الفيزيائية خصائص جديدة نسميها الكيمياء، مع أنها في جذورها تظل فيزياء تحكمها القوانين الفيزيائية المعروفة.
وبالمثل، فإن الحياة في علم الأحياء متولدة عن الكيمياء. وفي كل مرحلة من هذه المراحل يحدث تولد جديد. دعني أضرب مثالاً: الحياة نفسها، بدءاً من الخلية الحية الأولى البسيطة كالبكتيريا. ثم في الكائنات متعددة الخلايا، تظهر فجأة خصائص جديدة: الإدراك، الوعي. فالوعي ينبثق من الخلايا العصبية في أدمغتنا. هل تمتلك الخلية العصبية الواحدة إدراكاً؟ بالطبع لا. إنها مرة أخرى ظاهرة جماعية، فعندما تتجمع عدة عناصر – وهذا أساسي برأيي – تَنبَثِق فجأة خاصية جديدة، كأنما يظهر سلوك مختلف تماماً. هذه ظاهرة عميقة جداً في الطبيعة. وهذا ما أريد تسليط الضوء عليه. هذه نقطة مهمة يمكننا التوسع في مناقشتها في البودكاست الحالي.
أين تكمن الإشكالية بين الفيزياء والحياة؟ واحدة من أهم القوانين الفيزيائية هي ما يُعرف بالقانون الثاني للديناميكا الحرارية. وهذا القانون يتعلق بما نسميه “الإنتروبيا”. والإنتروبيا هي ظاهرة، بل صفة من صفات الطبيعة تقيس عدم الانتظام أو الفوضى.
أعطيك مثالاً نتعامل معه جميعاً: أنا جالسٌ الآن في مكتبي – هذا مكتبي في البيت – وعندي هنا كتب موضوعة على الطاولة. مع مرور الوقت، إذا لم أرتبها، ستتراكم الكتب ويتشكل منظر عشوائي تماماً. وكذلك الحديقة في البيت، إذا تركتها بلا رعاية تتحول إلى حالةٍ عشوائيةٍ متشابكة. هذا ما نسميه “الإنتروبيا”: أي زيادة في الفوضى وعدم الانتظام. وهذا ما تسعى الطبيعة لتحقيقه طوال الوقت. فالطبيعة تميل إلى الفوضى، وتميل إلى التجانس. وما المقصود بالفوضى؟ الفوضى تعني أن كل شيء يصبح متشابهاً ومختلطاً، أي أن المكونات تتداخل حتى تتجانس.
حتى نحافظ على الحياة – بل حتى نحافظ على الانتظام والنظام – يجب أن نبذل طاقة. هذا ما نفعله في الثلاجات والمجمدات. فالثلاجة تحافظ على البرودة – فمثلاً إذا وضعت مكعب ثلج في المجمد، يبقى مكعباً مادامت الحرارة منخفضة. ولكن حتى أحافظ على هذه البرودة، يجب أن أشغل الثلاجة وأمدها بالطاقة الكهربائية.
يقول القانون الثاني للديناميكا الحرارية ما يلي: إذا وجد نظام مغلق – أي نظام معزول عن الخارج – فإن عدم الانتظام، أي الإنتروبيا، يزداد فيه دائماً. فلماذا تحافظ الثلاجة على إنتروبيا منخفضة في داخلها؟ لأننا نزودها بالطاقة من الخارج، وهكذا فهي ليست نظاماً معزولاً. بل إن الثلاجة تطلق حرارة إلى الوسط المحيط بها. ففي المحصلة النهائية، إذا نظرنا إلى الثلاجة كنظام متكامل، نجد أنها تطلق حرارة إلى الخارج أكثر مما تبرد في الداخل.
هذا قانون أساسي في الفيزياء تم اكتشافه في القرن التاسع عشر من قبل عدة فيزيائيين بشكل مستقل، منهم لورد كلفن في إنجلترا. لكن الشخصين اللذين أسهاما بشكل كبير في تطويره هما العالم الاسكتلندي جيمس كليرك ماكسويل، والعالم النمساوي لودفيغ بولتزمان الذي يعتبر الركيزة الأساسية في صياغة هذا المفهوم.
فالطبيعة – إذا تركتَ لها العنان – تميل دائماً نحو الفوضى، لا نحو الانتظام والنظام. لكن الحياة في جوهرها قائمة على النظام. فأنا أنقل المعلومات داخلياً، والخلايا تتجدد طوال الوقت. والخلايا الجديدة التي تنشأ يجب أن تحافظ على نفس المعلومات التي كانت موجودة في الخلايا السابقة، وإلا يتشوه الإنسان أو الكائن الحي. وعندما نُنتج نسلاً جديداً – أي عملية التكاثر – فإننا ننقل معلومات من جيل إلى آخر، معلومات مُنظمة. فكيف تتمكن الحياة من الحفاظ على هذه المعلومات على الرغم من القانون الثاني للديناميكا الحرارية، الذي يميل إلى تدمير المعلومات وإلغاء الانتظام؟
فهذه هي المعضلة، والطريقة التي تحلُّ بها الحياة هذه المعضلة هي عبر عملية “الأيض” أو ما يُعرف بالميتابوليزم. فمبدأ حياتنا يقوم على أننا عندما نأكل، لماذا نأكل؟ لأن الطعام يحتوي على طاقة، وهذه الطاقة تُستهلك للحفاظ على انتظام الخلايا.
أعطيكم مثالاً من حياتنا اليومية: أنا زائد الوزن قليلاً، وأعلم أنه لا ينبغي لي أن أتناول أكثر من ألفَي سعرة حرارية في اليوم – والوحدة الصحية في الواقع هي الكيلوكالوري (ألف سعرة حرارية)، لكننا نستخدمها في الحديث العامي ونسميها “سعرة حرارية”. عندما تستخدم التطبيقات على الهاتف التي تخبرك بعدد السعرات التي تحرقها، أو عندما تمشي عشرة كيلومترات، فإنك تحرق حوالي 200 إلى 400 سعرة حرارية. لكننا نستهلك في المتوسط 2500 سعرة للرجال و 2000 للنساء في اليوم. أين تذهب الطاقة؟ إنها لا تذهب هباءً، بل يستهلكها الجسم للحفاظ على الانتظام الداخلي. وهذا ما يتم عبر عملية الأيض.
عندما يبحث العلماء في أصول الحياة، يتساءلون: ما هو التركيب الكيميائي أو المركبات التي مكنت من ظهور هذه العملية التي تستهلك الطاقة مع الحفاظ على الانتظام؟ أي تلك الخاصة بالحفاظ على النظام. وأول قوة في الطبيعة سمحت بذلك هي الجاذبية. فالجاذبية هي وسيلتنا لاستخراج طاقة مفيدة من الكون، منذ البدايات الأولى لنشوء النجوم، ومن هنا بدأ كل شيء. ولهذا السبب، وكما ذكرت سابقاً، فإن سياق وجودنا هو سياق كوني.
بالطبع، عندما بدأت الحياة، وُجدت عدة طرق لاستخلاص الطاقة وتحويلها وتوظيفها للحفاظ على الانتظام. فمثلاً، حتى أحافظ على بيتي أو حديقتي مرتبتين، لا بد أن أعمل فيهما باستمرار وأستمر في ترتيبهما. هذا هو تجسيدٌ عملي للقانون الثاني للديناميكا الحرارية.
فالحياة تمتلك إحدى آلياتها الأساسية – لا بمعنى الخداع، بل بمعنى الحيلة الذكية – وهي قدرتها على استهلاك الطاقة للحفاظ على الانتظام. وهذا الانتظام لا يبقى ساكناً، بل ينتقل ويتطور، ومع مرور الوقت يزداد تعقيداً، وينتقل إلى مستويات أعلى، لتبدأ بالانبثاق منه صفات جديدة. فمن خلية واحدة وكائنات وحيدة الخلية، تطور الأمر في مرحلة ما إلى تعاون عدة خلايا معاً، مشكلة كائناً متعدد الخلايا، تطورت فيه أجزاء متخصصة كالعين، وأخرى كاليد، تعمل بتناسق وتكامل للحفاظ على الكائن ككل. هذا هو الهيكل الأساسي للحياة.
والسؤال الجوهري الآن هو: ما القانون الفيزيائي الذي يمكّننا من تحقيق هذا الإنجاز؟ حتى اليوم، لا نملك إجابة قاطعة. هناك أبحاث ونظريات تقترح قوانين من هذا القبيل، ويُعد هذا المجال من المجالات المفتوحة للبحث: لماذا تطورت الحياة بطريقة تمكنها من التغلب على القانون الثاني؟ يبدو أن هناك قانوناً فيزيائياً أساسياً، في ظروف معينة، يسمح بحدوث ذلك.
فالحياة، في جوهرها، نظامٌ منتظم يستطيع الحفاظ على ذاته والتطور من جيل إلى آخر. هذه إحدى صفاتها الأساسية – مع أننا لا نملك تعريفاً واضحاً وشاملاً للحياة – إلا أن من أهم خصائصها هو التعقيد من ناحية، والانتظام من ناحية أخرى، وقدرتها على الاستنساخ: أي نقل المعلومات من خلية إلى أخرى، وعند تجدد الخلايا، وعند إنتاج أفراد جدد، حيث ننقل إليهم نظامنا، والقوانين الكامنة فينا، والمعلومات المخزنة في الحمض النووي DNA.
ففي هذا السياق، تبقى هناك قضية إشكالية، إشكاليات لم تُحل بعد. لكن هناك تطورات كبيرة في هذا المجال. أتمنى أن يكون حديثي واضحاً على الرغم من أنه معقد بعض الشيء.
– (المحاور): الوضوح تام يا دكتور.
السؤال الأخير ربما مرتبط جداً بهذا المحور، وأترك لكم أيضاً طرح أي محور آخر إذا كنت قد أغفلت شيئاً. بصراحة، كانت لدي أسئلة أخرى لكنني شعرت أنك غطيتها. جميع الأسئلة وخاصة السؤال الأخير حول الإنتروبيا والنظام والحفاظ على التعقيد. هنا قد يطرح شخص تساؤلاً: هل هناك غاية من الحياة؟ وأن العملية منذ نشأتها الأولى كانت لها غاية. فمن خلال هذا الحديث، قد يستمع أحدهم إلى هذا الحوار ويستنتج أننا نتحدث عن عملية بالغة التعقيد، يصعب حدوثها، وبالتالي فإن حدوثها بهذا الشكل – منذ اللحظة الأولى للكون حتى نشوء الكائنات عبر تعديلات كيميائية – هو أمر هادف. هل هذا صحيح؟
هذا موضوع فلسفي معقد وله تاريخه الطويل. وفي الطبيعة، عندما بدأ العلماء بتسجيل ودراسة الكائنات الحية، كان حوالي 90% من العث المنقط (العث المفلفل) أبيض اللون مع نقاط سوداء، بينما كان 10% فقط أسود اللون مع نقاط بيضاء. والسبب كان بسيطاً: هذا النوع من العث يعيش عادة على أشجار في إنجلترا ذات جذوع فاتحة اللون. فطيور التي تأكل هذا العث، ماذا تفعل؟ ترى العث الأسود ذا النقاط البيضاء بسهولة أكبر من العث الأبيض ذي النقاط السوداء، الذي يمتزج مع لون الجذع. لذا، فإن الـ 10% من العث الأسود هم الذين كانوا ينجون ويهربون من الطيور، بينما كانت الطيور تلتقط النوع الآخر بسهولة. وهذا هو السبب وراء dominance النسبة 90%.
ثم جاءت الثورة الصناعية. مع استخدام الفحم الحجري على نطاق واسع، تحولت جذوع تلك الأشجار فاتحة اللون إلى اللون الأسود بفعل الدخان والسناج. نتيجة لذلك، أصبح الطيور ترى العثَ فاتح اللون (ذي النقاط السوداء) بسهولة أكبر، فانقلبت الآية. وخلال فترة تراوحت بين عشرة وعشرين سنة – أو بضعة عقود – تحولت النسبة فأصبح 90% من العث المنقط من النوع الداكن (ذا النقاط البيضاء)، بينما تراجعت نسبة النوع الفاتح.
لاحقاً، وفي حدود الخمسينيات من القرن الماضي، وُضع قانون “الهواء النظيف” (Clean Air Act) في إنجلترا على مرحلتين، بعد أن أدركوا الأضرار البالغة للتلوث على البيئة وصحة البشر. وعندما طُبّق هذا القانون، بدأت جذوع الأشجار تعود تدريجياً إلى لونها الفاتح، وعاد معها التوازن إلى نسب العث كما كانت في السابق.
هل هناك غائية أو هدفٌ مُسبق وراء قدرة العث المنقط على التلاؤم مع لون الشجرة؟ لا يوجد أي غائية. أترى الفكرة؟ لا توجد أهدافٌ مقصودة في هذه الصفات التطورية. فمعظم صفاتنا ككائنات حية ليست غائية.
خذ الديناصورات مثلاً: عندما انقرضت، كانت – من حيث التنظيم الحراري – تشبه الزواحف في عصرنا، فهي من ذوات الدم البارد، ولم تكن تمتلك آلية داخلية لتنظيم حرارة جسمها بشكل مستقل. وعندما انخفضت درجات الحرارة globally بعد اصطدام النيزك بالأرض قبل 65 مليون سنة، بسبب السحابة الغبارية الهائلة التي حجبت الشمس، لم تستطع الديناصورات الصمود وهلكت. هل كان في انقراضها غاية أو تصميم مُسبق؟ لقد كان حدثاً عشوائياً محضاً. في المقابل، كانت الثدييات – بصغر حجمها آنذاك – تمتلك تلك الآلية الداخلية لتنظيم الحرارة (ذوات الدم الحار)، مما سمح لها بالنجاة. هل كان هناك هدفٌ وراء هذا الاختلاف؟ بالطبع لا.
هذا هو جوهر نظرية التطور: فالانتقاء هو عملية طبيعية تحدث نتيجة لتغير الظروف، وليس “بقاء الأقوى” بل بقاء الأكثر ملاءمةً للظروف السائدة. لا يوجد هدفٌ وراء هذه العملية، إنها محض صدفة. أمورٌ وقعت بمحض المصادفات التي تبدو لنا خيالية أحياناً. وهذا يُسقِط فكرة الغائية من أساسها في تفسير الحياة.
وحتى في الطب الحديث، عندما يصاب القلب بمرض، لا نستخدم تعبيرات غائية مثل “القلب يحاول أن يحسّن من حاله”، فهذه استعارات مجازية. ما يحدث هو تفاعلات كيميائية وحسب. لا غائية هناك، ولا أهداف. وهذا الفهم هو التحول الجذري الذي أحدثته نظرية التطور.
هذا يضعنا أمام معضلة فلسفية: فجزء من الكائنات الحية مثلنا، يصل في مرحلة ما إلى قدرة على – على سبيل المثال، أنا اليوم أقرر أن أتغدى بالباجة وأتحدث عن الأكلات الفلسطينية، أو أقرر أن آكل الباجرة ولا أريد أكل الملوخية. هذا يعني أن هناك نوعاً من القرار الغائي، القرار الحر: ماذا أفعل؟ أنا أقرر اليوم أن ألبس بلوزة خضراء، وغداً قد يخطر ببالي أن ألبس بلوزة حمراء. فهذا النوع من القدرة جاء مع تطور الإدراك والذكاء. وهنا ينشأ توتر بين هذه الصفات “الغائية” الظاهرة وبين أصلها التطوري غير الغائي.
والأمر أن الإدراك ليس حكراً علينا – فحرية الاختيار هذه ليست مقصورة على البشر. فمثلاً، عندي في البيت قطة، ويمكنك أن ترى أنها تُفكر. عندما تريد القفز من خزانة إلى أخرى، تتأمل هل تستطيع القفز أم لا؟ أن ترى فيها إدراكاً واضحاً. فهي تريد أن تأكل هذا الطعام اليوم، ولا تريد أن تأكل ذاك الطعام غداً، أو تفضل نوعاً آخر. فالإدراك موجود ليس فقط عندنا، بل عند الرئيسيات (Primates)، وهي الكائنات المتطورة مثل القرود. والكلاب لديها إدراك، والدلافين لديها إدراك، بل وإدراك ذكي، ليس مجرداً بل متطوراً.
وليس الأمر مقصوراً على الثدييات فقط – فقد ذكرت سابقاً الرئيسيات وذكرت أيضاً الطيور، ونعلم ذلك: فالببغاوات معروفة بهذا.
هناك فيلم – دعوني أعود إلى – هناك فيلم على اليوتيوب كُتب على أساسه كتاب، والفيلم عنوانه Mama’s Last Hug (الضمّة الأخيرة). “Mama” هو اسم – وليس المقصود “أم” – إنه اسم لقردة في حديقة حيوانات في أرنهم، كانت القردة الأم المسيطرة (Matriarch)، وكانت لها علاقة – كان هناك طبيب – أو باحث في علم الرئيسيات، يأتي ليعالجها ويرعاها، ولكنه أيضاً يدرسها، وتطورت علاقة بينهما. وقد لاحظنا دائماً وجود مثل هذه العلاقات. في نهاية حياتها، كانت هذه القردة في حالة واضحة أنها تحتضر، كانت تموت، فانطوت على نفسها.
ماذا يُظهر الفيلم؟ يُظهر الفيلم اللحظة التي رأت فيها هذه القردة الطبيب – وهو فيلم مؤثر جداً، يصعب على المشاهد ألا يتأثر به – فعندما رأت الطبيب، اقتربت منه واحتضنته وربتت على رأسه، وكأنها تقول له: “أنا بخير، لا تقلق على حالتي”. ثم تركتَه وعادت إلى مكانها لتموت. إنه مشهد مؤثر للغاية.
واللافت أن هذه الكائنات، رغم تطورها، ليست بشراً مثلنا. فالكثير من الكائنات الحية – ليس معظمها، لكن عدداً كبيراً منها – يمتلك إدراكاً ووعياً.
الإدراك ليس حكراً على الثدييات. وكما ذكرت سابقاً، الإدراك ليس مقصوراً على الثدييات، بل يشمل أيضاً طيوراً مثل الببغاوات. فالببغاوات تمتلك إدراكاً ذاتياً. وقد أُجريت تجارب عديدة مع الببغاوات والغربان. دعوني أذكر مثالاً عن الغراب: في تجربة شهيرة، وُضعت مرآة في قفص الغراب. في البداية، عندما يقف الغراب أمام المرآة يرى انعكاساً فيظنه غراباً آخر، فيحاول البحث خلف المرآة عن ذلك الغراب. ثم بعد فترة يدرك أن هذا الانعكاس هو صورته. فماذا يفعل بعد ذلك؟ يبدأ بأداء حركات أمام المرآة – تماماً كما كنا نفعل ونحن صغار عندما نقف أمام المرآة ونقوم بحركات بالوجه – يبدأ الغراب بفعل الشيء نفسه.
بل أجروا تجربة أكثر تعقيداً: وضعوا نقطة حمراء على رقبة الغراب ثم وضعوه أمام المرآة. فبدأ الغراب بتحريك رأسه ومحاولة لمس النقطة على رقبته، مدركاً أنها موجودة على جسده هو. وهذا دليل واضح على الإدراك الذاتي. إنها ظاهرة مذهلة حقاً.
في العشرين سنة الأخيرة، تتسع دائرة اكتشافاتنا عن الإدراك لتشمل أنواعاً من الكائنات البحرية مثل الأخطبوط. فقد اكتشفنا أن للأخطبوط عدداً هائلاً من الخلايا العصبية، موزعة بين رأسه وأذرعه. بل يمكن القول إن للأخطبوط “تسعة عقول”: عقل مركزي في رأسه، وثمانية عقول صغيرة في أذرعه، تعادل في قدراتها الإدراكية عقل كلب. ويمكن للإنسان أن يبني علاقة مع أخطبوط، ونعلم اليوم أن الأخطبوط يحلم أثناء نومه. هذه الأمور موثقة علمياً.
فالإدراك، كما يتبين، ليس حِكراً على البشر، بل تطور على الأقل ثلاث مرات بشكل مستقل في فروع مختلفة من شجرة الحياة. فقد انفصلت الأخطبوطات والرخويات الأخرى عن السلالة التي أدت إلى ظهور البشر والطيور منذ حوالي خمسمائة مليون سنة. بينما انفصل خطنا التطوري عن خط الطيور منذ حوالي مئتين وأربعين مليون سنة. وهذا يدل على أن الطبيعة تعيد تشكيل ظاهرة الإدراك بشكل مستقل في سياقات تطورية متباينة، مما يشير إلى أنه ناتج حتمي في ظل ظروف تطورية معينة.
ودعوني أختتم بهذه النقطة الأخيرة. لقد تطرقتَ إلى أن الطبيعة تنتج تعقيداً كاملاً، ولكن هذه جزء من الحقيقة فقط. ففي الواقع، معظم الكائنات الحية على الأرض لا تزال وحيدة الخلية. إذا تساءلنا: ما أكثر أشكال الحياة انتشاراً على كوكبنا؟ لكانت الإجابة هي البكتيريا. وهناك نوع آخر بسيط يسمى العتائق (Archaea)، وهو مجموعة تطورت بشكل منفصل عن البكتيريا منذ الخلية الأولى. هذه الأشكال البسيطة هي التي تشكل الأغلبية الساحقة للحياة.
ما يحدث هو أن التعقيد يظهر أحياناً، لكن السمة الغالبة للحياة هي البساطة لا التعقيد. فمن الأسهل للحياة أن تنتج كائنات بسيطة بكثير من أن تنتج كائنات معقدة. وهنا أيضاً نجد تفسيراً آخر لدحض فكرة الغائية: فوجود الحياة البسيطة بكثرة هو دليل على أن ظهورها يتم بالمصادفة وبسهولة نسبية مقارنة بالحياة المعقدة.
أتمنى أن أكون قد أوفيتُ في الإجابة عن أسئلتك. دكتور، شكراً جزيلاً لك على وقتك الثمين. سنقوم بمشارعة الكتاب وروابط شرائه، وأتمنى أن تتاح هذه الفرصة لمزيد من المتابعين والقراء لقراءته. وأنصح الجميع به، كما أتمنى أن تُتَرجَم نسخة إنجليزية منه، فأرى أن أفكاره استثنائية ونادرة. شكراً مرة أخرى على هذا الحوار الثري. – (رد الدكتور): العفو، شكراً لك عزيزي. شكراً جزيلاً.